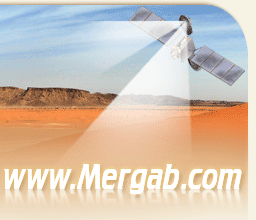 |
 |
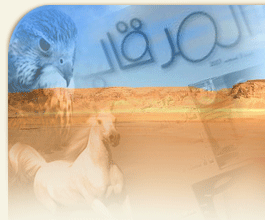 |
||
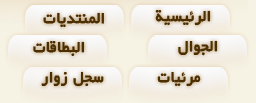 |
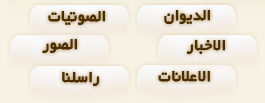 |
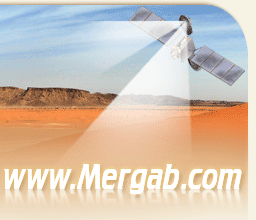 |
 |
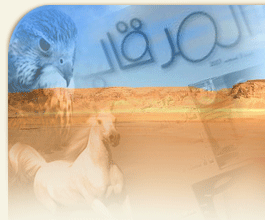 |
||
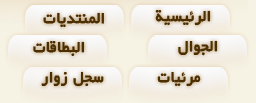 |
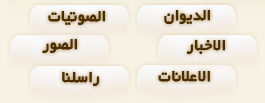 |
|
|
 |
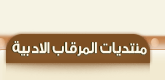 |
|
|||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
| ..: المرقاب للأدبِ والثّقَافَةِ :.. الشعر الحر - النقد البنّاء - دراسات أدبيّة |
 |
|
|
أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#23 |
|
(*( عضوة )*)
 |
تسلم يا محمد على تواجدك وتفاعلك الطيب
والله لا هنت |
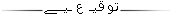
 المرأة تبقى. مرأة ومن تقول انها لا تحتاج إلى رجل في حياتها. فهي. كاذبه. أو لم تكتشف هذي الحقيقه إلى الان. ?. 
|
|
|
#24 |
|
(*( عضوة )*)
 |
[align=right]
المقنع الكندي أحد شعراء العصر الأموي اسمه هو محمد بن ظفر بن عمير بن أبي شمر بن الأسود بن عبد الله الكندي، ينتسب على قبيلة كندة وهي من اعرق القبائل اليمنية واشهرها والتي عرفت بسيادتها، ولد بوادي دوعن في حضر موت. يرجع المؤرخون لقب المقنع الذي عرف به لأن القناع كان من صفات الرؤساء وكان المقنع الكندي يعرف بمكانته ومنزلته الرفيعة داخل عشيرته كما قال الجاحظ، وقال التبريزي في تفسيره للقب أن المقنع هو اللابس لسلاحه، وكل من غطى رأسه فهو مقنع، كما قيل أنه كان شديد الجمال فكان يستر وجهه مخافة العين عرف الكندي بنسبه لعائلة عريقة فكان جده عمير سيد كندة، وورث ابنه ظفر الرئاسة عنه، وقد نشأ شاعرنا في وسط هذا وعرف بالإنفاق وحب العطاء فانفق ما تركه له والده حتى أصبح مديوناً، وجاءت إحدى قصائده "الدالية" معبرة عن حاله بعد استدانته من أبناء عمه، وتعد هذه القصيدة من أطول القصائد التي كتبها، واشهرها، وفي هذه القصيدة قام بالرد على أقاربه بعدما عاتبوه على كثرة إنفاقه والاستدانة منهم، فهو الكريم الذي لا يرد سائل، فدافع عن نفسه في هذه القصيدة وقال فيها: يُعاتِبُني في الدينِ قَومي iiوَإِنَّما دُيونيَ في أَشياءَ تُكسِبُهُم حَمدا أَلَم يَرَ قَومي كَيفَ أوسِرَ مَرَّة وَأُعسِرُ حَتّى تَبلُغَ العُسرَةُ الجَهدا فَما زادَني الإِقتارُ مِنهُم iiتَقَرُّباً وَلا زادَني فَضلُ الغِنى مِنهُم بُعدا أَسُدُّ بِهِ ما قَد أَخَلّوا وَضَيَّعوا ثُغورَ حُقوقٍ ما أَطاقوا لَها iiسَدّا وَفي جَفنَةٍ ما يُغلَق البابُ iiدونها مُكلَّلةٍ لَحماً مُدَفِّقةٍ iiثَردا وَفي فَرَسٍ نَهدٍ عَتيقٍ iiجَعَلتُهُ حِجاباً لِبَيتي ثُمَّ أَخدَمتُه iiعَبدا وَإِن الَّذي بَيني وَبَين بَني أَبي وَبَينَ بَني عَمّي لَمُختَلِفُ جِدّا أَراهُم إِلى نَصري بِطاءً وَإِن iiهُم دَعَوني إِلى نَصرٍ أَتيتُهُم شَدّا فَإِن يَأكُلوا لَحمي وَفَرتُ iiلحومَهُم وَإِن يَهدِموا مَجدي بنيتُ لَهُم iiمَجدا وَإِن ضَيَّعوا غيبي حَفظتُ iiغيوبَهُم وَإِن هُم هَوَوا غَييِّ هَوَيتُ لَهُم رُشدا وَلَيسوا إِلى نَصري سِراعاً وَإِن هُمُ دَعوني إِلى نَصيرٍ أَتَيتُهُم شَدّا وَإِن زَجَروا طَيراً بِنَحسٍ تَمرُّ iiبي زَجَرتُ لَهُم طَيراً تَمُرُّ بِهِم iiسَعدا وَإِن هَبطوا غوراً لِأَمرٍ يَسؤني طَلَعتُ لَهُم ما يَسُرُّهُمُ iiنَجدا فَإِن قَدحوا لي نارَ زندٍ يَشينُني قَدَحتُ لَهُم في نار مكرُمةٍ iiزَندا وَإِن بادَهوني بِالعَداوَةِ لَم iiأَكُن أَبادُهُم إِلّا بِما يَنعَت iiالرُشدا وَإِن قَطَعوا مِنّي الأَواصِر iiضَلَّةً وَصَلتُ لَهُم مُنّي المَحَبَّةِ iiوَالوُدّا وَلا أَحمِلُ الحِقدَ القَديمَ iiعَلَيهِم وَلَيسَ كَريمُ القَومِ مَن يَحمِلُ الحِقدا فَذلِكَ دَأبي في الحَياةِ iiوَدَأبُهُم سَجيسَ اللَيالي أَو يُزيرونَني iiاللَحدا لَهُم جُلُّ مالي إِن تَتابَعَ لي iiغَنّى وَإِن قَلَّ مالي لَم أُكَلِّفهُم iiرِفدا وَإِنّي لَعَبدُ الضَيفِ ما دامَ iiنازِلاً وَما شيمَةٌ لي غَيرُها تُشبهُ iiالعَبدا عَلى أَنَّ قَومي ما تَرى عَين iiناظِرٍ كَشَيبِهِم شَيباً وَلا مُردهم مُرداً بِفَضلٍ وَأَحلام وجودِ iiوَسُؤدُد وَقَومي رَبيع في الزَمانِ إِذا iiشَدّا لم يتم جمع أشعاره في ديوان وتفرق الكثير منها، ولم تكن قصائد الكندي طويلة فكان أطولها القصيدة الدالية، و من بعدها قصيدة تضم 18 بيت وباقي القصائد تتراوح بين سبعة أبيات وبيت واحد، وتدور معظم قصائده في نفس إطار القصيدة الدالية والتي سبق ذكرها، وقد أنشد الكندي بعض أشعاره بين يدي عبد الملك بن مروان، وتوفى عام 70هـ. إِنّي أُحَرِّض أَهلَ البُخلِ iiكُلِّهُم لَو كانَ يَنفَعُ أَهلَ البُخلِ iiتَحريضي ما قَلَّ ماليَ إِلّا زادَني iiكَرَماً حَتّى يَكونَ برزقِ اللَهِ iiتَعويضي وَالمالُ يَرفَعُ مَن لَولا iiدَراهِمُهُ أَمسى يُقَلِّب فينا طرفَ iiمَخفوضِ لَن تُخرِج البيضُ عَفواً مِن اكُفِّهُم إِلا عَلى وَجَعٍ مِنهُم وَتَمريضِ كَأَنَّها مِن جُلودِ الباخِلينَ iiبِها عِندَ النَوائِبِ تُحذى iiبِالمَقاريضِ يعتبر المقنع الكندي شاعر مقل، ويكشف شعره عن شخصيته، فتتمتع ألفاظه بالسلاسة، بالإضافة لرصانة أسلوبه وانتقائه للألفاظ والمفردات الشعرية، وتكراره للألفاظ من أجل تأكيد وتوصيل الفكرة. نَزَلَ المَشيبُ فَأَينَ تَذهَبُ iiبَعدَهُ وَقَد ارعَويتَ وَحانَ مِنكَ iiرَحيلُ كانَ الشَبابُ خَفيفَةٌ iiأَيّامُهُ وَالشَيبُ مَحمَلُه عَلَيكَ iiثَقيلُ لَيسَ العَطاءُ من الفُضولِ سَماحَةً حَتّى تَجودَ وَما لَدَيكَ iiقَليلُ [/align] |

|
|
|
#25 |
|
(*( عضوة )*)
 |
[align=right]
ابن الأحنف شاعر الحب العذري هو العباس بن الأحنف بن الأسود الحنفي كُنيته أبو الفضل من بني حنيفة "شريف النسب", ولد في اليمامة بنجد ونُسب إليها, وكان أهله في البصرة وقتذاك, نشأ وترعرع في بغداد وعاش بها أهم أيام حياته, وتوفي سنة 192 هجريًا الموافق 807 ميلاديًا, وعنه قال البحتري: "أغزل الناس". العباس هو خال إبراهيم بن العباس الصولي, وأحد شعراء العصر العباسي، عرف بوسامته وجمال هيئته, تمتعت ألفاظه بالبساطة والجمال, وله نوادر كثيرة, ولديه قوة احتمال كبيرة, وكان محبوباً من قبل قومه فلا يبخل بمد يد المساعدة لكل من يحتاجه. كان للعباس صلة بالخليفتين العباسيين: هارون الرشيد والمهدي, ولكنه كان اقرب من الرشيد حيث أحتل عنده مكانة كبيرة فقربه ونعّمه، وأصطحبه في العديد من حملاته، مما قاله ابن الأحنف في مرافقته للرشيد [poem=font="Simplified Arabic,5,crimson,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black""] إِنَّما حَبَّبَ المَسيرَ إِلَينا=أَنَّنا نَستَطيبُ ما تَستَطيبُ ما نُبالي إِذا صَحِبنا أَمينَ اللَهِ=هارونَ أَن يَطولَ المَغيبُ[/poem] تغزل ابن الأحنف في كثير من النساء ومن أشهرهن "فوز" والتي قدم لها قصيدة باسمها, كما نال غزله لها من ديوانه نصيب كبير حوالي ثلاثة أرباعه تقريبًا, وكانت الحب الثاني في حياة ابن الاحنف هي "ظلوم". مما قاله في محبوبته "فوز" أَلَم تَعلَمي يا فَوزُ أَنّي مُعَذَّبُ بِحُبِّكُمُ وَالحَينُ لِلمَرءِ يُجلَبُ وَقَد كُنتُ أَبكيكُم بيَثرِبَ مَرَّةً وَكانَت مُنى نَفسي مِنَ الأَرضِ يَثرِبُ أُؤَمِّلُكُم حَتّى إِذا ما iرَجَعتُمُ أَتاني صُدودٌ مِنكُمُ وَتَجَنُّبُ فَإِن ساءَكُم ما بي مِنَ الضُرِّ فَاِرحَموا وَإِن سَرَّكُم هَذا العَذابُ فَعَذِّبوا فَأَصبَحتُ مِمّا كانَ بَيني وَبَينَكُمُ أُحَدِّثُ عَنكُم مَن لَقيتُ فَيَعجَبُ وَقَد قالَ لي ناسٌ تَحمَّل دَلالَها فَكُلُّ صَديقٍ سَوفَ يَرضى وَيَغضَبُ وَإِنّي لَأَقلى بَذلَ غَيرِكِ فَاِعلَمي وَبُخلُكِ في صَدري أَلَذُّ وَأَطيَبُ وَإِنّي أَرى مِن أَهلِ بَيتِكِ نُسوَةً شَبَبنَ لَنا في الصَدرِ ناراً تَلَهَّبُ عَرَفنَ الهَوى مِنّا فَأَصبَحنَ حُسَّداً يُخَبِّرنَ عَنّا مَن يَجيءُ وَيَذهَبُ وقال في "ظلوم" أَظَلومُ حانَ إِلى القُبورِ ذَهابي وَبَليتُ قَبلَ المَوتِ في أَ ثوابي فَعَلَيكِ يا سَكَني السَلامُ فَإِنَّني عَمّا قَليلٍ فاعلَمِنَّ حِسابي جَرَّعتِني غُصَصَ المَنِيَّةِ بِالهَوى أَفَما بِعَيشِكِ تَرحَمينَ شَبابي سُبحانَ مَن لَو شاءَ سَوّى بَينَنا وَأَدالَ مِنكِ لَقَد أَطَلتِ عَذابي شعره وأسلوبه في الكتابة كان شعر ابن الأحنف مميز عن شعراء عصره وذلك يرجع إلى انفراده بنوع واحد من أنواع الشعر وهو الغزل فتميز فيه وأتقنه, وفيه قال الجاحظ: " لولا أن العباس بن الأحنف أحذق الناس وأشعرهم وأوسعهم كلاما وخاطرا، ما قدر أن يكثر شعره في مذهب واحد لا يجاوزه، لأنه لا يهجو ولا يمدح لا يتكسب ولا يتصرف، وما نعلم شاعرا لزم فنا واحدا فأحسن فيه وأكثر". أمَّا شِعرُه فكان ذي طابع سلس وفيه عذوبة ورقة ملحوظتين في موسيقاه, وكانت الصياغة واللغة عنده فيها قوة ومتانة, وألفاظه كانت عفيفة غير متكلفة كل من يقرأها يفهمها, ومن كثرة عذوبة ورقة وجمال موسيقاه وأشعاره وبساطة وخفة بحوره الشعرية؛ كان مشاهير عصره من المغنيين وعلى رأسهم إبراهيم الموصلي يتغنون بمعظم قصائده. أمَّا بالنسبة لأسلوبه عامة فكان كثير الحوار وسرد القصص والأحداث, فكان يسلب لب المستمعين له بأسلوبه السلس الشيق في رواية الأحداث والوقائع بما تحمله من مشاعر وأحاسيس يخطف بها قلب القارئ أو المتلقي لشعره. وعرف عن العباس أنه كان لا يتكسب من شعره أي شيء غير المتعة ولا شيء غيرها, فكان شعره عبارة غزل عفيف, فالعباس كان لا يهجو ولا يمدح, غزل ولا شيء إلا الغزل. قال في الغزل أَميرَتي لا تَغفِري ذَنبي فَإِنَّ ذَنبي شِدَّةُ الحُبِّ يا لَيتَني كُنتُ أَنا المُبتَلى مِنكِ بِأَدنى ذَلِكَ ا لذَنبِ حَدَّثتُ قَلبي كاذِباً عَنكُمُ حَتّى اِستَحَت عَينَيَ مِن قَلبي إِن كانَ يُرضيكُم عَذابي وَأَن أَموتَ بِالحَسرَةِ وَالكَربِ فَالسَمعُ وَالطاعةُ مِنّي لَكُم حَسبي بِما تَرضَونَ لي حَسبي [/align] |

|
|
|
#26 |
|
(*( عضوة )*)
 |
جميل بن معمر.. من قوم إذا أحبو ماتوا!!
[align=right]
عندما يكون الشاعر عاشق يبدع فما بال شاعر ولد في قبيلة عرف أهلها بكثرة العشق ورقة القلوب، فهنا ينطلق لسان الشاعر ليجود بأعذب الألفاظ، أما الشاعر فهو جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي كنيته أبو عمرو وشهير "بجميل بثينة" أحد شعراء العصر الأموي، والقبيلة هي "عُذرة" ومسكنها في وادي القرى بين الشام والمدينة. عرفت هذه القبيلة بالجمال والعشق حتى قيل لإعرابي من العذريين: "ما بال قلوبكم كأنها قلوب طير تنماث - أي تذوب - كما ينماث الملح في الماء؟ ألا تجلدون؟ قال: إنا لننظر إلى محاجر أعين لا تنظرون إليها. قيل لأخر فمن أنت؟ فقال من قوم إذا أحبوا ماتوا، فقالت جارية سمعته: عُذريٌّ ورب الكعبة. وربما جاء الكلام السابق ليوضح لنا خلفية القبيلة التي نشأ وترعرع فيها شاعرنا جميل بن معمر هذا الشاعر مرهف الحس رقيق المشاعر والذي هام حباً ببثينة والتي انطلق يقول فيها الشعر حتى وفاته. عشق جميل قول الشعر وكان لسانه مفطوراً على قوله فيقال أنه كان راوية لهدبة بن خشرم، وهدبة كان شاعراً وراوية للحطيئة وهو أحد الشعراء المخضرمين. قصة عشقه عرف جميل بعشقه لبثينة والتي هام بها حباً وعندما تقدم لطلب الزواج منها قوبل طلبه بالرفض، فأخذ في إنشاد الشعر في حبه لها، ثم اتجه للوم والعتاب عليها بعد انصرافها عنه وزواجها من أخر، وعندما بالغ في هجاء أهلها استعدوا عليه السلطان والذي أمر بإهدار دمه، فخرج جميل من البلاد هائماً متنقلاً بين الشام واليمن ثم نزل إلى مصر وافداً على عبد العزيز بن مروان والذي أكرمه وأمر له بمنزل فأقام فيه قليلاً ثم مات، وجاءت وفاة جميل عام 82هـ - 701م. مما قاله في حبه لبثينة وَمَن يُعطَ في الدُنيا قَريناً كَمِثلِها فَـذَلِكَ فـي عَيشِ الحَياةِ رَشيدُ يَموتُ الهَوى مِنّي إِذا ما لَقيتُها وَيَـحـيا إِذا فـارَقتُها فَـيَعودُ يَـقولونَ جاهِد يا جَميلُ بِغَزوَةٍ وَأَيَّ جِـهـادٍ غَـيرُهُنَّ أُريـدُ لِـكُلِّ حَـديثٍ بَـينَهُنَّ بَشاشَةٌ وَكُـلُّ قَـتيلٍ عِـندَهُنَّ شَـهيدُ شعره يعد جميل رائد شعراء الحب العذريين، فكان أكثر شعره في الغزل والفخر، فيذوب شعره رقة من فرط المشاعر، وكان مقلاً في المدح، ويتميز الشعر العذري بشكل عام بالعفاف تنعكس عليه أثار البيئة الإسلامية، بالإضافة لعمق المشاعر وشفافيتها، ولا ينظم هؤلاء الشعراء غزلهم في وصف مفاتن المرأة الجسدية فكان غزلهم عفيف يهيمون حباً بامرأة واحدة فقط فيعرف كل واحد بمحبوبته مثل شاعرنا اليوم والذي عرف بـ "جميل بثينة" وتستفيض أبياتهم الشعرية في وصف معاناة الفراق ولوعة العشق. اِرحَـميني فَقَد بَليتُ فَحَسبي بَعضُ ذا الداءِ يا بُثَينَةُ حَسبي لامَـني فيكِ يا بُثَينَةُ صَحبي لا تَلوموا قَد أَقرَحَ الحُبُّ قَلبي زَعَـمَ الـناسُ أَنَّ دائي طِبّي أَنـتِ وَالـلَهِ يـا بُثَينَةُ طِبّي قال سهل بن سعد الساعدي: لقيني رجل من أصحابي فقال هل لك في جميل فإنه ثقيل؟ فدخلنا عليه وهو يكيد بنفسه، وما يخيل لي أن الموت يكرثه - يشتد عليه – فقال لي: يا "بن سعد" ما تقول في رجل لم يزن قط، ولم يشرب الخمر قط، ولم يقتل نفساً حراماً قط، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟. فقلت: اظنه والله قد نجا، فمن هذا الرجل؟. قال:أنا. قلت: والله ما سلمت وأنت منذ عشرين سنة تشبب ببثينة. قال إني في أخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، فلا نالتني شفاعة محمد "صلى الله عليه وسلم" يوم القيامة إن كنت وضعت يدي عليها لريبة قط. فما قمنا حتى مات. عَـجِلَ الـفِراقُ وَلَيتَهُ لَم يَعجَلِ وَجَـرَت بَـوادِرُ دَمعِكَ المُتَهَلِّلِ طَرَباً وَشاقَكَ ما لَقيتَ وَلَم تَخَف بَـينَ الحَبيبِ غَداةَ بُرقَةِ مِجوَلِ وَعَرَفتَ أَنَّكَ حينَ رُحتَ وَلَم يَكُن بَـعدُ اليَقينُ وَلَيسَ ذاكَ بِمُشكِلِ لَـن تَـستَطيعَ إِلى بُثَينَةَ رَجعَةً بَـعدَ الـتَفَرُّقِ دونَ عـامٍ مُقبِلِ [/align] |

|
|
|
#27 |
|
(*( عضو )*)
|
جَرير الخطفي
جَرير 28 - 110 هـ / 648 - 728 م جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي، أبو حزرة، من تميم. أشعر أهل عصره، ولد ومات في اليمامة، وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه غير الفردق والأخطل. كان عفيفاً، وهو من أغزل الناس شعراً. حيــــــاتـــه: هو جرير بن عطية، ينتهي نسبة إلى قبيلة"تميم" نشأ في اليمامة ومات ودفن فيها . كان من أسرة عادية متواضعة.. وقف في الحرب الهجائية وحده أمام ثمانين شاعرًا، فحقق عليهم النصر الكبير، ولم يثبت أمامه سوى الفرزدق والأخطل. كان عفيفًا في غزله،متعففًا في حياته، معتدلا بعلاقاته وصداقاته.. كما كان أبيًا محافظًا على كرامته، لاينام على ضيم، هجاء من الطراز الأول، يتتبع في هجائه مساوىء خصمه، وإذا لم يجد شيئًا يشفي غلته، اخترع قصصًا شائنة وألصقها بخصمه، ثم عيره بها.. اتصل بالخلفاء الأمويين، ومدحهم ونال جوائزهم،.. سلك في شعره الهجاء والمديح والوصف والغزل.. عاش حوالي ثمانين سنة. اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاة جرير، على أنه في الأغلب توفي سنة 733م/144ه وذلك بعد وفاة الفرزدق بنحو أربعين يومًا، وبعد وفاة الأخطل بنحو ثلاث وعشرين سنة. المديح عند جرير أكثر جرير من المديح ، وكانت نشأته الفقيرة، وطموح نفسه، وموهبته المواتية، وحاجة خلفاء بني أمية إلى شعراء يدعون لهم، ويؤيدون مذهبهم، كان كل ذلك مما دفعه إلى الإكثار من المدح والبراعة فيه. وكان أكثر مدائحه في خلفاء بني أمية وأبنائهم وولاتهم، وكان يفد عليهم من البادية كل سنة لينال جوائزهم وعطاياهم. وكان مديحه لهم يشيد بمجدهم التليد ويروي مآثرهم ومكارمهم، ويطيل في الحديث عن شجاعتهم، ويعرض بأعدائهم الثائرين عليهم، وبذلك كان يظهر اتجاهه السياسي في ثنايا مدحه لهم، وكان إذا مدح استقصى صفات الممدوح وأطال فيها، وضرب على الوتر الذي يستثيره ولم يخلط مدائحه وبلغت غايتها من التأثير في النفس. وفي الحق أنه ما كان لجرير من غاية غير التكسب وجمع المال، فلم يترفع عن مدح أي شخص أفاض عليه نوافله، حتى أنه مدح الموالي.. ذلك أن طمع جرير وجشعه وحبه للمال كانت أقوى من عصبيته القبلية، ولم يكن لرهطه من الشرف والرفعة مثل ما لرهط الفرزدق، لهذا شغل الفرزدق بالفخر بآبائه وعشيرته، وقال أكثر مدائحه في قبيلته، وحتى في مدائحه لبني أمية لم ينس الفخر بآبائه وأجداده. فهو (جرير) إذا مدح الحجاج أو الأمويين بالغ في وصفهم بصفات الشرف وعلو المنزلة والسطوة وقوة البطش، ويلح إلحاحا شديدا في وصفهم بالجود والسخاء ليهز أريحيتهم، وقد يسرف في الاستجداء وما يعانيه من الفاقة.. وتكثر في أماديحه لهم الألفاظ الإسلامية والاقتباسات القرآنية.. ولا يسعنا إلا الاعتراف بأن جريرًا كان موفقا كل التوفيق، حين صور منزلة الأمويين وجودهم بقوله: ألستم خير من ركب المطاياوأندى العالمين بطون راح جرير مفاخرًا هاجيًا عاصر الشاعر "عبيد الراعي" الشاعرين جريرًا والفرزدق، فقيل إن الراعي الشاعر كان يسأل عن هذين الشاعرين فيقول: - الفرزدق أكبر منهما وأشعرهما. فمرة في الطريق رآه الشاعر جرير وطلب منه أن لا يدخل بينه وبين الفرزدق، فوعده بذلك.. ولكن الراعي هذا لم يلبث أن عاد إلى تفضيل الفرزدق على جرير، فحدث أن رآه ثانية، فعاتبه فأخذ يعتذر إليه، وبينما هما على هذا الحديث، أقبل ابن الراعي وأبى أن يسمع اعتذار أبيه لجرير، حيث شتم ابن الراعي الشاعر جريرًا وأساء إليه.. وكان من الطبيعي أن يسوء ذلك جريرًا ويؤلمه، فقد أهين إهانة بالغة ، فذهب إلى بيته، ولكنه لم يستطع النوم في تلك الليلة، وظل قلقا ساهرا ينظم قصيدة سنورد بعض أبياتها بهذه المناسبة، فلما أصبح الصباح ، ألقاها الشاعر جرير في "المربد" على مسمع من الراعي والفرزدق والناس، فكانت القصيدة شؤما على بني نمير, حتى صاروا إذا سئلوا عن نسبهم لا يذكرون نسبهم إلى "نمير" بل إلى جدهم عامر.. هذا وقد سمى جرير قصيدته هذه" الدامغة" لأنها أفحمت خصمه: أعـد الله للشعــراء مـنـي صواعـق ... يخضعـــون لها الــــرقـــابـــــا أنا البازي المطل على نميــــــــــــر ... أتيح من السماء لها انصبابا فلا صلـى الإله علـى نميــــــــــــــر ... ولا سقيـت قبــورهُم السحابـا ولــو وزنـت حلوم بني نميــــــــــــر ... على الميزان ما وزنت ذبابــا فغـض الطـرف إنك من نميــــــــــر ... فـلا كعبـاً بلغـت ، ولا كـلابـا إذا غضيـت عليـك بنو تميـــــــــــــم ... حسبــت النـاس كلهم غضابـا معاني الابيات واضحة وسهلة، تتصف بهجاء الخصم وإلحاق العيوب والمساوىء به، كما أنها تتصف أيضا بفخر الشاعر بنفسه، عدا عن أن الشاعر يتهكم بخصمه وبقومه، فيسخر من عقولهم الصغيرة كعقول الذباب، ثم يطلب الشاعر من خصمه أن يتوارى عن الأنظار ويخجل من نفسه هو وقومه. ويختتم القصيدة ببيت رائع شهير بالفخر. فالفخر هو الوجه الآخر للهجاء، فالطرف الذي يتلقى الهجاء من الشاعر، يجده فخرًا بالنسبة لنفسه ولقومه.. فهنا يفاخر جرير بمجده ومجد قومه فخرًا جاهليًا، يعتز فيه ببطولتهم وأيامهم القديمة وما ورثوا من مجد، فهو قد هيأ هجاءه لكل الشعراء الذين تحدثهم نفسهم بالتعرض بأنني سأقضي عليهم وأحطم عزهم.. أو يكف الشعراء بعد أن قلت كلمتي الفاضلة، أم يطمعون في التعرض لي، ليقاسوا من هجائي نارًا تلفح وجوههم لفحًا؟ فالهجاء عند جرير شديد الصلة بالفخر، فهو إذا هجا افتخر، وجعل من الفخر وسيلة لإذلال خصمه. تابع ,,, |
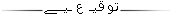
ayeth_@hotmail.com
لـ نتواصل 
|
|
|
#28 |
|
(*( عضو )*)
|
أما موضوع فخره في نفسه وشاعريته، ثم قومه وإسلامه. فإذا هجا الفرزدق اصطدم بأصل الفرزدق الذي هو أصله، فكلاهما من"تميم" ، وإذا هجا الأخطل فخر بإسلامه ومضريته، وفي مضر النبوة والخلافة: قال الاخطل: إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل الخلافة والنبوة فينـا هذا وكان لجرير مقدرة عجيبة على الهجاء، فزاد في هجائه عن غيره طريقة اللذع والإيلام.. فيتتبع حياة مهجويه وتاريخ قبيلتهم، ويعدد نقائصهم مختلفا، مكررا، محقرا، إلا أنه لم يستطع أن يجعل الفخر بآبائه موازيا لفخر الفرزدق. شيء من غزل جرير لم يكن غزل جرير فنا مستقلا في شعره، فقد مزج فيه أسلوب الغزل الجاهلي بأسلوب الغزل العذري. فهو يصف المرأة ويتغزل بها، ثم يتنقل من ذلك إلى التعبير عن دواخل نفسه، فيصور لنا لوعته وألمه وحرمانه، كما يحاول رصد لجات نفسه فيقول: يا ام عمـرو جـزاك الله مغفـرة!ردي ... علـي فـــــؤادي مثلـــمـا كـــــانــا لقد كتمت الهـوى حتـى تهيـمنـــــــي ... لا أستـطيـع لهـذا الحـب كتمانـا إن العيون التي في طرفـــهـــا حـورٌ ... قتــلنــنـا، ثـم لـم يحييـن قتــلانــا يصرعن ذا اللهيب حتى لا حراك به ... وهـن أضعــف خلـق الله إنسانــا يتغزل الشاعر بامرأة تدعى"أم عمرو"، وسواء أكانت هذه المرأة حقيقية أم من خيال الشاعر، كما جرت العادة لدى أكثر الشعراء الغزليين، فهو يطلب منها أن تعيد له قلبه الذي سرقته منه... ثم يصف ألمه وحبه الذي أصيب به، حتى لم يستطع إخفاءه طويلا.. ثم يتغزل بجمال عيون محبوبته النجل. هذه العيون التي قضت عليه من شدة جمالها ولمعانها، تلك العيون الفتاكه التي بواسطتها تسلط البارعات في الجمال سهاما قاتلة للمحبين، بالرغم من أنهن، كما يقال من الجنس الناعم والضعيف.. جرير ورثاء زوجته الرثاء لدى جرير قسمان: قسم خص به أهل بيته كامرأته وابنه، وقسم خص به بعض رجالات الدولة من الشخصيات الهامة.. ولما كان جرير عاطفيا، شديد التأثر، كان رثاؤه، بشكل عام، رقيقا، صادقا، نابعا من القلب، ويؤثر في القلب.. فها نحن نراه في شعره يرثي زوجته بعد وفاتها فيقول: لولا الحياء لها جني استعبار ... ولزرت قبرك والحبيب يـزار ولهت قلبي إذ علتني كبـــــرة ... وذوو التمائم من بنيك صغار صلى الملائكة الذين تخيـروا ... والطيبــون عليـك والأبــــرار لا يلبث القرناء أن يتفــرقـوا ... الليــل يـكـر عليهـــم ونـهـــار ففي هذه الأبيات نرى نفسه حزينة حين يرثي الشاعر زوجته المتوفاة. ونراه فيها يقع بين صراع تفرضه عليه العادات والتقاليد، وبين آلامه وأحزانه ومحبته لزوجته.. إنه الآن قد فقد زوجته، أم أولاده، وقد أصبح متقدما في سنه، فقد كبر وكاد أن يتحطم، فهو بعد وفاة زوجته أصبح مسؤولا عن تربية أطفاله الصغار ورعايتهم بعد رحيل أمهم عنهم.. ثم ينتهي إلى التسليم بأمر الله ثم يدعو لها أن ترعاها الملائكة، لأنها كانت زوجة وفية صالحة.. إنه يكتم_ إن استطاع- أحزانه- وليس له إلا الصبر والإيمان فهذه هي الدنيا، ولا شيء يدوم، وكل إنسان لا بد أن يرحل إن عاجلا وإن آجلا، فما دامت هنالك حياة، فهناك أيضا الموت. رثاء خاص هذا وقد رثى جرير نفسه حين رثى خصمه الفرزدق وحاول أن يقول فيه كلمة حلوة في أواخر عمره، ومما قال: لتبك عليه الإنس والجن إذ ثـوى فتى مضر، في كل غرب ومشرق فتى عاش يبني المجد تسعين حجة وكان إلى الخير والمجـد يرتقـي أسلوب جرير أول ما يطالعنا في أسلوب جرير، سهولة ألفاظه ورقتها وبعدها عن الغرابة، وهي ظاهرة نلاحظها في جميع شعره، وبها يختلف عن منافسيه الفرزدق والأخطل اللذين كانت ألفاظهما أميل إلى الغرابة والتوعر والخشونة. وقد أوتي جرير موهبة شعرية ثرة، وحسا موسيقيا، ظهر أثرهما في هذه الموسيقى العذبة التي تشيع في شعره كله. وكان له من طبعه الفياض خير معين للإتيان بالتراكيب السهلة التي لا تعقيد فيها ولا التوا.. فكأنك تقرأ نثرا لا شعرا. ومن هنا نفهم ما أراده القدماء بقولهم: (جرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخر)، وهذا القول يشير إلى ظاهرة أحرى في الشاعرين، وهي أن جريرا كان أكثر اعتمادا على الطبع من الفرزدق، وأن الفرزدق كان يلقى عناء شديدًا في صنع شعره. وإن اعتماد جرير على الطبع وانسياقه مع فطرته الشعرية من الأمور التي أدت أيضا إلى سهولة شعره وسلاسة أسلوبه ورقة ألفاظه، إذ كان لشعره موسيقى تطرب لها النفس، ويهتز لها حس العربي الذي يعجب بجمال الصيغة والشكل، ويؤخذ بأناقة التعبير وحلاوة الجرس أكثر مما يؤخذ بعمق الفكرة والغوص على المعاني. ولهذا أبدع جرير في أبواب الشعر التي تلائمها الرقة والعذوبة، كالنسيب والرثاء.. على أن انسياق جرير مع الطبع وقلة عنايته بتهذيب شعره وإعادة النظر فيه، كل ذلك جعل من الابتكار والإبداع في المعاني قليلا، لا يوازي حظ الفرزدق من ذلك، حتى أنك لتنظر في بعض أبياته فلا تجد فيها غير صور لفظية جميلة جذابة، لا يكمن وراءها معنى مبتكر ولا فكرة طريفة.. فاقرأ مثلا أبياته الغزلية في هذا المجال، تجد أنها معان مكررة، لا جدة فيها ولا طرافة، قد وضعت في قالب لفظي جديد وعرضت عرضا جديدا..ففي هذه الصور والقوالب تظهر براعة جرير وافتنانه، أما سعة الخيال وتوليد المعاني وطرافة الأفكار، فحظ جرير منها دون حظ الفرزدق، وإلى هذا الأمر أشار" البحتري" حين فضل الفرزدق على جرير لتوليده المعاني، مع أن البحتري كان في طريقته تلميذا لجرير، ينحو نحوه في رقة الألفاظ وسلاسة الأسلوب. وكان لحياة جرير البدوية أثرها الكبير في شعره، كما كان لها أثرها في نفسه.. فتأثير النشأة البدوية واضح من جزالة ألفاظه ورقتها وسهولتها، وبداوة صوره وأخيلته.. إلا أن شعر جرير لم يخلص لأثر البادية وحدها، فقد كان للقرآن الكريم أثره في شعره، إذ لطف فيه من طابع البداوة، وكان له أثره في رقة ألفاظه وسهولة أسلوبه، كما كان له أثر في معانيه وأفكاره. ولا نرى جريرا يكثر من الصور البيانية في قصيدته هذه أو تلك.. ففي شعره يظهر الأسلوب البدوي، فهو قريب التناول جميل التعبير. فنية جرير الشعرية الشاعر جرير من النفوس ذات المزاج العصبي وذات الطبع الناعم الرقيق، ولئن جعلت رقة الطبع شعره دون شعر الفرزدق فخامة، لقد جعلته يتفوق في المواقف العاطفية كالرثاء. فالعاطفة هي منبع كل شيء في شعر جرير، وهي عنده تطغى على العقل والخيال، ولهذا ضعف تفكيره كما ضعف خياله ووصفه، فجرى على توثب إحساسه الذي يثيره أقل تهويش، وتستفزه المؤثرات العاطفية. وقد اجتمعت العاطفة عند جرير إلى قريحة فياضة، فكان شعره ينسكب عن طبع غني . وكأن الشاعر فعلا يغرف من بحر. فلا يجهد بشعره، ولا يعمد إلى التفاف وتنقيح ونحت كالفرزدق، بل يسيل شعره سيلانا في سهولة، تمتد بامتداد قصائده الطويلة، وفي خفة ولباقة تعبير، وموسيقى لفظية أخاذة، بجانب الوضوح ولآسر. وجرير، وإن كان شاعر الطبع والعاطفة المتدفقة، لم يسلم أحيانا من الصنعة وتطلب التأثير بألوان من الأساليب الفنية اللفظية. وهكذا كان جرير أقدر من الأخطل والفرزدق على نقض الكلام وأشد فتنة، وأغنى قريحة وأرق عاطفة ولفظا، وأوضح كلاما وأوفر انسجاما ونغما موسيقيا، إلا أنه دون الأخطل والفرزدق خيالا وتفكيرا وجزالة. أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم.. وأن أكون وفقت في نقلي المعلومات .. دمتم سالمين .. |

|
|
|
#30 |
|
(*( عضوة )*)
 |
ابن بُرد.. ما بين الهجاء والفخر
[align=right]
بشار بن برد العُقيلي، أبو معاذ، أحد الشعراء المتميزين في عصر ما بين الدولتين، أدرك كل من الدولتين الأموية والعباسية، وينتسب إلى امرأة عقيلية والتي قيل أنها أعتقته من الرق، ويعد بشار من أشعر المولدين على الإطلاق، عرف بميله للهجاء والذم والذي كثر في الكثير من أشعاره. ولد ضريراً عام 95هـ - 713م أصله فارسي من طخارستان غربي نهر جيحون، نشأ في البصرة بالعراق وقدم إلى بغداد، عاصر الدولة الأموية في فترة شبابه وذلك قبل أن تأخذ في الانحسار تدريجياً ليحل محلها الدولة العباسية. قال الشعر وهو في سن مبكرة وعرف عنه إقباله الشديد على الدنيا والنهل من جميع متعها فكان دائماً متهافتاً على الخمر والنساء والغناء والمجون والخلاعة، ينطلق لسانه بالهجاء والذم في أبيات شعرية لجميع مالا يعجبه مما جعل الناس يخافون لسانه، فلقد كان كارهاً للناس نافراً منهم وجريئاً في هجائهم، دائم التفاخر بأصله الفارسي ومتحاملاً على العرب. ولبشار الكثير من الشعر المتفرق وهو من الطبقة الأولى والذي جمع بعضه في ديوان، وكان معظم شعره في فنون المدح والهجاء والغزل والفخر، فكان يجعل أشعار المدح سبباً في إدرار الأموال عليه والتي ينفقها على ملذاته ومتعه وعلى العكس من هذا فكان يقوم بهجاء مالا يعطه المال هجاءاً شديداً لاذعاً، حضر بشار عصر جرير والفرزدق وكان معجباً بجرير حتى أن أحد أشعاره تضمنت أبياتاً من شعر جرير ونذكره فيما يلي: وَذاتُ دَلٍّ كَـــأَنَّ الــبَـدرَ صـورَتُـها بـاتَت تُـغَنّي عَـميدَ الـقَلبِ سَـكرانا إِنَّ الـعُيونَ الَّـتي فـي طَرفِها حَوَرٌ قَـتَـلـنَـنا ثُـــمَّ لَـــم يُـحـيـينَ قَـتـلانـا فَـقُلتُ أَحـسَنتِ يا سُؤلي وَيا أَمَلي فَـأَسـمِعيني جَــزاكِ الـلَـهُ إ ِحـسانا يــا حَـبَّـذا جَـبـلُ الـرَيّانِ مِـن جَـبَلٍ وَحَـبَّـذا سـاكِـنُ الـرَيّـانِ مَـن كـانا قالَت فَهَلّا فَدَتكَ النَفسُ أَحسَنَ مِن هَـذا لِـمَن كانَ صَبَّ القَلبِ حَيرانا يـا قَومُ أُذني لِبعَضِ الحَيِّ عاشِقَةٌ وَالأُذنُ تَـعشَقُ قَـبلَ الـعَينِ أ َحـيانا وبالنظر للبيت الثاني نجده قد تردد في أحد قصائد جرير والتي قال فيها: يـا رُبُّ عـائِذَةٍ بِـالغَورِ لَـو شَـهِدَت عَــزَّت عَـلَيها بِـدَيرِ الـلُجِّ شَـكوانا إِنَّ الـعُيونَ الَّـتي فـي طَرفِها حَوَر قَـتَـلـنَـنا ثُـــمَّ لَـــم يُـحـيِـينَ قَـتـلانـا يَصرَعنَ ذا اللُبَّ حَتّى لا حِراكَ بِهِ وَهُــنَّ أَضـعَفُ خَـلقِ الـلَهِ أ َركـانا وفاته تم اتهامه بالزندقة من قبل الخليفة العباسي المهدي والذي أمر بقتله فقيل أنه مات ضرباً بالسياط وتم دفنه بالبصرة، فكانت وفاته في عام 167هـ - 783م، وقيل عن هذه الواقعة أن بشار قام بمدح الخليفة المهدي ولما لم يقم الخليفة بإعطائه الجوائز والأموال نظير مدحه انقلب عليه وقام بهجاؤه هو ووزيره يعقوب بن داود حيث تجاوز جميع الحدود في الهجاء فأمر الخليفة بقتله. من أشعاره ذَهَــــبَ الــدَهــرُ بِـسِـمـطٍ وَبَـــرا وَجَــرى دَمـعِـيَ سَـحّاً فـي الـرِدا وَتَـــأَيَّـــيــتُ لِــــيَــــومٍ لاحِـــــــقٍ وَمَضى في المَوتِ إِخوانُ الصَفا فَـــفُـــؤادي كَــجَــنـاحَـي طـــائِــرٍ مِــن غَــدٍ لا بُــدَّ مِـن مُـرِّ الـقَضا وَمِـــــنَ الـــقَــومِ إِذا نـاسَـمـتُـهُم مَـلِـكٌ فـي الأَخـذِ عَـبدٌ فـي الـعَطا يَـــســأَلُ الــنــاسَ وَلا يُـعـطـيـهُمُ هَــمُّـهُ هـــاتِ وَلَـــم يَـشـعُر بِـهـا وَأَخٍ ذي نـــيـــقَـــةٍ ي َـــســأَلُــنــي عَــــن خَـلـيـطَيَّ وَلَـيـسـا بِــسَـوا قُــلـتُ خِـنـزيـرٌ وَكَــلـبٌ حـــارِسٌ ذاكَ كَــالــنـاسِ وَهَــــذا ذو نِــــدا فَــخُـذِ الـكَـلـبَ عَــلـى مــا عِـنـدَهُ يُــرعِـبُ الــلِـصَّ وَيُـقـعي بِـالـفِنا قَــــلَّ مَــــن طــــابَ لَــــهُ آبـــاؤُهُ وَعَــلــى أُمّــاتِــهِ حُــسـنُ الـثَـنـا ومما قاله بشار في عشقه لعبدة وهي إحدى الجواري التي ولع بها. أَعَـبـدَةُ قَــد غَـلَـبتِ عَـلى فُـؤادي بِــدَلِّـكِ فَـاِرجِـعي بَـعـضَ الـفُـؤادِ جَـمَـعتِ الـقَلبَ عِـندَكِ أُمَّ عَـمروٍ وَكـــانَ مُـطَـرَّحـاً فـــي كُـــلِّ وادِ إِذا نـادى الـمُنادي بِـاِسمِ أُخـرى عَلى اِسمِكِ راعَني ذاكَ المُنادي كَـمـا أَفـسَـدتِني عَـرَضـاً فَـهـاتي صَـلاحي قَـد قَـدَرتِ عَلى ف َسادي مَــلَـكـتِ فَـأَحـسِـني وَتَـخَـلَّـصيني مِـــنَ الـبَـلـوى بِـحُـبِّـكِ وَالـبِـعـادِ فَـإِنّـي مِـنكِ يـا بَـصَري وَسَـمعي وَمِــن قَـلـبي حَـمَـيتُكِ فـي جِـهادِ [/align] |

|
|
|
#31 |
|
(*( عضو )*)
|
لبيد بن ربيعة
..
( ت نحو 661 م ) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، ويتصل نسبه بقيس عيلان بن مضر بن نزار ويكنى أبا عقيل . وأمّه تامِر _ وقيل تامرة _ بنت زنباغ العبسيّه بنت جذيمة بن رواحة . ولقد أدرك لبيد الاسلام واسلم وحسن اسلامه ، وهو من أشراف العرب الأجواد المعدودين فيها . وهو شاعر مخضرم ، عاش في الجاهلية تسعين عاماً وفي الاسلام خمسه وخمسين عاماً ، ونستطيع أن نعتبره بذلك أحد معمري العرب . فقد عمر العرب مائه وخمساً واربعين سنة حتى إنه قال : ولقد سئمت من الحياة وطولها *** وسؤال هذي الناس كيف لبيدُ نزل الكوفة في خلافة عُمَر بن الخطّاب فأقام فيها ، ومات هناك في خلافة معاوية بن ابي سفيان . عمّه ابو البراء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنّة . وللبيد أخ من أمّه هو أربد بن قيس الذي وفد على الرّسول _ صلى الله عليه وسلم _ مع عامر بن طفيل. وكان لبيد خير شااعر برّ قومَه وأحسن اليهم وفاخر الناس بمآتيم . وممن عاصره من الشعراء ابو محجن الثقفي الذي شهد يوم القادسيه ، والحطيئة جرول بن أوس ، وهو من فحول الشعراء ، وعمرو بن معد يكرب ثمّ الزبيدي وهو من سادات أهل اليمن ، وابو خراش خويلد بن مُرَة الذي ماات في خلافَة عُمَر. وقالَ في خولة : طلَلٌ لخولة بالرّسيس قديمِ *** بمعاقِلٍ فالأنعمين فشومِ وفي سلمى قال : ألم تلمم على الدّمن البوالي *** لسلمى بالمذايبِ فالقفالِ في إحدى قصاائده التي رثى فيهاا أخاه أربد خاطب ابنته مي قال : يا مَيّ قومي في المآتِمِ واندُبي *** فتىً كان مِمّن يجتني المجد أروَعا وقولـي ألا لا يبعد اللّه أربداً *** وهدّي بـه صدع الـفؤاد المفجّعا لحا اللّه هذا الدّهرَ إني رأيتهُ *** بصيراً بـما ساءَ ابن آدم مـولعا لعمرو أبيك الخير يا ابنة أربَد *** لـقد شفّني حـزن أصـاب فأوجعا ذكر لبيد في شعره النّوار وهي معشوقته قال : أو لم تكن تدري نوارُ بأنني *** وصـال عقـد حبائِـلً جـذّامُها ترّاك أمكنة إذا لـم أرضـها *** أو يتعلق بعض النفوس حمامُها بل أنت لا تدرين كم من ليلةٍ *** طـلق لـذيذ لـهوُها وندامُـها وقال مفاخراً بنفسه وذاكراً من النساء هنداً وأسماء وأم طارق : أتيت أبـا هند بهند ومـالكاً *** بأسماء اني مـن حماة الحقائق دعتني وفاضت عينها بخدورًة *** فجئت غشاشاً إذ دعت أم طارِقِ كان لبيد في الجاهلية خير شاعر لقومه يمدحهم ويرثيهم ويعد أيامهم ووقائعهم وفرسانهم. وشعره فخم شريف المعاني يدور أكثره على الحماسة والفخر والمديح والرثاء والوصف ، وله خطب أيضًا . انقسم الرواة والنقاد في شأن لبيد ، فمنهم من يزعم أن لبيد لم يقل في الإسلام شعرًا ، ومنهم من يزعم أنه قال شعرًا . ويقال إنه لم يقل في الإسلام إلا بيتًا واحدًا : الحمد لله الذي لم يأتني أجلي .. حتى اكتسيت من الإسلام سربالا ودمتم سالمين,, |

|
|
|
#32 |
|
(*( عضوة )*)
 |
[align=right]
أحد الشعراء المتميزين في العصر العباسي، هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء، أبو علي، كنيته أبو نواس، شاعر العراق في عصره، قام بنظم جميع الأنواع الشعرية، وكان واحداً من شعراء الطبقة الأولى، ولكنه أكثر في نظم الشعر المتعلق بوصف الخمر، فعرف أبو نواس بشاعر الخمر فكان لا ينافسه شاعر أخر في وصفه لها. ويرجع لأبو نواس الفضل في تحرير الشعر من اللهجة البدوية، ونظمه بالطريقة الحضرية. وقد اخذ عليه الكثيرين عبثه ومجونه وانصرافه للخمر على الرغم من جودة شعره، إلا أن الخمر قد اذهب عقله فما يكاد يفيق منها حتى يرجع لها مرة أخرى، إلا انه أتجه إلى الزهد في أواخر حياته فقال البعض انه تاب عما كان فيه وقد انشد عدد من الأشعار التي تدل على ذلك. النشأة ولد أبو نواس عام 146هـ - 763م بالأهواز من بلاد خوزستان، ونشأ بالبصرة كان والده من جند مروان بن محمد الأموي، انتقل إلى العراق بعد زوال ملك مروان ولجأ إلى قرية من قرى الأهواز، وفيها ولد الحسن، وكان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي، أمير خراسان فنسب إليه. نشأ أبو نواس بالبصرة وفيها تلقى العلم على يد كبار العلماء في اللغة والنحو وغيرها، ثم رحل إلى بغداد فاتصل فيها بالخلفاء من بني العباس، وقام بمدح عدد منهم وخرج إلى دمشق وهناك اتصل بعدد من شعرائها، ثم رحل إلى مصر فمدح أميرها، وعاد إلى بغداد مرة أخرى، فأقام بها إلى أن توفي فيها في عام 198هـ - 813 م. كانت تتسم حياة أبو نواس باللهو والمجون وأكثر شعره كان في وصف الخمر، وقد اتهم بالزندقة وتم حبسه بواسطة الخليفة الأمين، نتيجة لمجونه وفسقه. شعر وعشق عشق أبو نواس إحدى الجواري بالبصرة، وكانت تدعى "جنان" وكانت جميلة تروي الأشعار والأخبار، وقد هام بها ونظم فيها الكثير من الأشعار والتي نذكر منها: أَيـــــــا مُــلــيــنَ الــحَــديــدِ لِــعَــبــدِهِ داوُودِ أَلِـــــن فُــــؤادَ جِــنــانٍ لِــعـاشِـقٍ مَــعـمـودِ قَـد صـارَتِ الـنَفسُ مِنهُ بَينَ الحَشا وَالوَريدِ جِنانُ جودي وَإِن عَززَكِ الهَوى أَن تَجودي أَلا اِقـتُـلـيـنـي فَــفــي ذاكَ راحَــــةٌ لِـلـعَـمـيدِ أَمـا رَحِـمتِ اِشـتِياقي أَمـا رَحِـمتِ سُهودي أَمـــا رَأَيـــتِ بُـكـائـي فــي كُــلِّ يَــومٍ جَـديـدِ قالوا عنه قال عنه الجاحظ "أن شعره يصل للقلب دون استئذان"، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله " لولا مجون أبي نواس لأخذت العلم منه"، وقال ابن منظور " كان أبي نواس عالماً بكل فن، وكان الشعر اقل بضاعته". من شعره وَقُـلتُ إِنّي نَحوتُ الخَمرَ أَخطُبُها قـالَ الـدَراهِمَ هَـل لِـلمَهرِ إِبـطاءُ لَـمّـا تَـبَـيَّنَ أَنّــي غَـيـرُ ذي بَـخَـلٍ وَلَـيـسَ لـي شُـغُلٌ عَـنها وَإِبـطاءُ أَتـى بِـها قَـهوَةً كَـالمِسكِ صافِيَةً كَـدَمـعَةٍ مَـنَـحَتها الـخَـدَّ مَـرهـاءُ مـا زالَ تـاجِرُها يَسقي وَأَشرَبُها وَعِـنـدَنا كـاعِـبٌ بَـيضاءُ حَـسناءُ كَــم قَــد تَـغَـنَّت وَلا لَــومٌ يُـلِمُّ بِـنا دَع عَنكَ لَومي فَإِنَّ اللَومَ إِغراءُ ومن شعره أيضاً مُــتَــيَّــمُ الــقَــلــبِ مُــعَــنّـاهُ جـادَت بِـماءِ الـشَوقِ عَيناهُ يَـقـولُ وَالـدَمـعُ عَـلـى خَـدِّهِ مِــن وَجــدِهِ وَالـحُزنُ أَبـكاهُ ما أَنفَعَ الهَجرَ لِأَهلِ الهَوى أَجـدى مِـنَ الـهِجرانِ مَعناهُ فَـإِن شَـكا يَـوماً جَـواً باطِناً قـــالَ لَـــهُ صَــبـراً وَعَــزّاهُ إِن كـانَ أَبـكاكَ الهَوى مَرَّةً فَــطـالَ مــا أَضـحَـكَكَ الـلَـهُ لا خَـيرَ في العاشِقِ إِلّا فَتىً لاطَــــــفَ مَــــــولاهُ وَداراهُ وَدافَــــعَ الــهَـجـرَ وَأَيّــامَـهُ فَـالـوَصلُ لا شَــكَّ قُـصـاراهُ جانب أخر لأبو نواس وعلى الرغم من فجور أبو نواس ومجونه إلا انه كانت له إحدى القصائد الهامة التي قالها في طوافه بالبيت الحرام أثناء الحج والتي قال فيها: إِلَــهَـنـا مــــا أَعــدَلَـك مَـلـيكَ كُــلِّ مَــن مَـلَك لَـبَّـيـكَ قَـــد لَـبَّـيتُ لَــك لَـبَّـيـكَ إِنَّ الـحَـمدَ لَــك وَالـمُلكَ لا شَـريكَ لَـك مــا خــابَ عَـبدٌ سَـأَلَك أَنــتَ لَــهُ حَـيـثُ سَـلَك لَـــولاكَ يــا رَبُّ هَـلَـك لَـبَّـيـكَ إِنَّ الـحَـمدَ لَــك وَالـمُلكَ لا شَـريكَ لَـك كُـــــلُّ نَـــبِــيٍّ وَمَــلَــك وَكُـــلُّ مَــن أَهَــلَّ لَــك وَكُــــلُّ عَــبــدٍ سَــأَلَـك سَــبَّـحَ أَو لَــبّـى فَــلَـك لَـبَّـيـكَ إِنَّ الـحَـمدَ لَــك وَالـمُلكَ لا شَـريكَ لَـك وَالـلَـيلَ لَـمّـا أَن حَـلِك وَالـسابِحاتِ في الفَلَك عَلى مَجاري المُنسَلَك لَـبَّـيـكَ إِنَّ الـحَـمدَ لَــك وَالـمُلكَ لا شَـريكَ لَـك اِعــمَـل وَبــادِر أَجَـلَـك وَاِخـتُـم بِـخَـيرٍ عَـمَـلَك لَـبَّـيـكَ إِنَّ الـحَـمدَ لَــك وَالـمُلكَ لا شَـريكَ لَـك وشعر أخر نظمه يدل على ندمه قال فيه يـا رَبِّ إِن عَظُمَت ذُنوبي كَثرَةً فَـلَقَد عَـلِمتُ بِـأَنَّ عَفوَكَ أَعظَمُ إِن كـانَ لا يَـرجوكَ إِلّا مُحسِنٌ فَـبِمَن يَـلوذُ وَيَـستَجيرُ المُجرِمُ أَدعوكَ رَبِّ كَما أَمَرتَ تَضَرُّعاً فَـإِذا رَدَدتَ يَـدي فَـمَن ذا يَرحَمُ مـا لـي إِلَـيكَ وَسـيلَةٌ إِلّا الرَجا وَجَـميلُ عَـفوِكَ ثُـمَّ أَنّـي مُـسلِمُ [/align] |

|
|
|
#33 |
|
(*( عضوة )*)
 |
[align=right]
 أبو القاسم بن محمد بن أبي القاسم الشابي شاعر تونسي، وينتمي لشعراء العصر الحديث، أطلع على الشعر العربي القديم والحديث بالإضافة للشعر الغربي وكانت له أرائه الأدبية المميزة، عاني أبو القاسم الشابي من المرض الذي أودى بحياته وهو ما يزال في ريعان الشباب، وعلى الرغم من رحلته القصيرة في هذه الحياة إلا أنه قدم عدد من المؤلفات، بالإضافة لديوان شعر تضمن قصائده التي قدمها خلال حياته. تميز الشابي بأشعاره الرومانسية، ولغته المشرقة وكان أحد صور التجديد في المدرسة الشعرية الكلاسيكية. النشأة ولد أبو القاسم الشابي عام 1909م بقرية الشابية من ضواحي توزر عاصمة الواحات التونسية بالجنوب، كان والده محمد الشابي قاضياً تلقى دراسته بالأزهر الشريف بمصر وحصل على الإجازة المصرية، وقد كان أبو القاسم مرافقاً لوالده في جميع المدن التونسية التي عمل بها. حصل أبو القاسم على شهادة الابتدائية ثم أنتقل إلى تونس العاصمة وهناك واصل دراسته الثانوية بجامع الزيتونة، درس كل من الفقه واللغة العربية وكان دائم الذهاب إلى المكتبة للإطلاع على المزيد من الكتب، فكانت كل من مكتبة قدماء الصادقية والمكتبة الخلدونية هما المكانين الأساسيين اللذان يفد عليهما أبو القاسم ليستقي معارفه فأطلع على الأدب العربي القديم والحديث، والدواوين الشعرية، كما سعى للإطلاع على الأدب الأوروبي عن طريق المترجمات العربية، بالإضافة لحرصه على حضور المجالس الأدبية والفكرية. بعد أن أنتهي الشابي من دراسته الثانوية قام بالالتحاق بمدرسة الحقوق بتونس وحصل منها على شهادته في الحقوق عام 1930م. رحلته الأدبية والشعرية قدم أبو القاسم الشابي العديد من الآراء الجريئة والتي عبر عنها في كتاب " الخيال الشعري عند العرب" والذي استعرض فيه كل ما أنتجه العرب من شعر، فتحدث فيه عن الصورة الشعرية واضعاً الأمثلة الدالة على ما يذهب إليه الشعر العربي في العصور المختلفة، وعمل على عقد مقارنة بين نماذج من الشعر العربي ومقتطفات من أدب الغرب، وذلك ليثبت أن العرب تمسكوا بالصورة المادية في شعرهم وجعلوا منها محور القول والتفكير وأن الغرب تمعنوا أكثر فيما وراء الماديات مما زاد في الخرافات والأساطير في الشعر والنثر عندهم. عكف أبو القاسم الشابي على كتابة الشعر والإطلاع على الكتب الأدبية وحضور المجالس الأدبية وعلى الرغم من فترة حياته القصيرة إلا انه تمكن من إصدار عدد من المؤلفات وقدم العديد من القصائد الشعرية المتميزة. قام بكتابة مذكراته وله ديوان شعر مطبوع بعنوان " أغاني الحياة"، وكتاب الخيال الشعري عند العرب، وأثار الشلبي، ومذكرات.  تميز شعر أبو القاسم الشابي بالرومانسية وحب الطبيعة، وقد سيطر عليه في بعض قصائده إحساسه بالخوف من الموت ورفضه له فظهرت قصائده محتوية على الكثير من الأسى، وقد دعا أبو القاسم في شعره إلى تأمل النفس وحب الطبيعة، وظهر إحساسه العميق بكل ما يحيط به، وقد تضمن شعره العديد من العناصر فعبر عن الكون والحياة والموت والبشر والحب والمرأة. مما قاله: سَأعيشُ رَغْمَ الدَّاءِ ii والأَعداءِ كالنَّسْر فوقَ القِمَّةِ ii الشَّمَّاءِ أرْنُو إلى الشَّمْسِ المُضِيئةِ هازِئاً بالسُّحْبِ والأَمطارِ والأَنواءِ لا أرْمقُ الظِّلَّ الكئيبَ ولا أرَى مَا في قَرارِ الهُوَّةِ ii السَّوداءِ وأَسيرُ في دُنيا المَشَاعرِ حالِماً غَرِداً وتلكَ سَعادةُ ii الشعَراءِ أُصْغي لمُوسيقى الحَياةِ وَوَحْيِها وأذيبُ روحَ الكَوْنِ في ii إنْشَائي وفي قصيدة أخرى يقول ليتَ لي أنْ أعيشَ في هذه ii الدُّنيا سَعيداً بِوَحْدتي ii وانفرادي أصرِفُ العُمْرَ في الجبالِ وفي ii الغاباتِ بَيْنَ الصّنوبرِ ii الميَّادِ لَيْسَ لي من شواغلِ العيشِ مَا يصرف نَفْسي عنِ استماع ii فؤادي أرْقُبُ الموتَ والحياةَ ii وأصغي لحديثِ الآزالِ ii والآبادِ وأغنِّي مع البلابلِ في الغابِ وأُصْغي إلى خريرِ ii الوادي وأُناجي النُّجومَ والفجرَ والأطيارَ والنَّهرَ والضّياءَ الهادي الوفاة جاءت وفاة والد أبا القاسم لتكون واحدة من الضربات الموجعة التي تلقاها في حياته، هذا بالإضافة لإصابته بداء في القلب ومعاناته في ظل المرض وملازمته للفراش حتى جاءت وفاته، توفي أبو القاسم الشابي وهو ما يزال في ريعان الشباب عام 1934م وتم دفنه بروضة الشابي بقريته. من قصائده نذكر أَيُّها الشَّعْبُ ليتني كنتُ حطَّاباً فأهوي على الجذوعِ ii بفأسي ليتني كنتُ كالسُّيولِ إِذا ii سالتْ تَهُدُّ القبورَ رمساً ii برمسِ ليتني كنتُ كالرِّياحِ ii فأطوي كلَّ مَا يخنقُ الزُّهُورَ بنحسي ليتني كنتُ كالشِّتاءِ ii أُغَشِّي كلّ مَا أَذْبَلَ الخريفُ بقرسي ليتَ لي قوَّةَ العواصفِ يا شعبي فأَلقي إليكَ ثَوْرَةَ ii نفسي قصيدة "صلوات في هيكل الحب" عذبة أنت كالطفولة ii كالأحلام كاللحن كالصباح ii الجديد كالسَّماء الضَّحُوكِ كاللَّيلَةِ القمراءِ كالوردِ كابتسامِ الوليدِ يا لها مِنْ وَداعةٍ ii وجمالٍ وشَبابٍ مُنعَّمٍ ii أُمْلُودِ يا لها من طهارةٍ تبعثُ ii التَّقديسَ في مهجَةِ الشَّقيِّ ii العنيدِ يا لها رقَّةً تَكادُ يَرفُّ الوَرْدُ منها في الصَّخْرَةِ الجُلْمودِ أَيُّ شيءٍ تُراكِ هلْ أَنْتِ ii فينيسُ تَهادتْ بَيْنَ الوَرَى مِنْ ii جديدِ قصيدة إرادة الحياة إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ ii الحياةَ فلا بُدَّ أنْ يَسْتَجيبَ ii القدرْ ولا بُدَّ للَّيْلِ أنْ ii ينجلي ولا بُدَّ للقيدِ أن ii يَنْكَسِرْ ومَن لم يعانقْهُ شَوْقُ الحياةِ تَبَخَّرَ في جَوِّها واندَثَرْ فويلٌ لمَنْ لم تَشُقْهُ ii الحياةُ من صَفْعَةِ العَدَمِ ii المنتصرْ [/align] |

|
|
|
#34 |
|
(*( عضوة )*)
 |
المهلهل بن ربيعة
[align=right]
عدي بن ربيعة بن مرّة بن هبيرة من بني جشم، من تغلب، أبو ليلى، المهلهل، كما يعرف بلقب الزير، شاعر وأحد أبطال العرب في الجاهلية، وهو خال امرئ القيس، وجد الشاعر عمرو بن كلثوم، أطلق عليه لقب "مهلهلاً" لأنه أول من هلهل نسج الشعر أي رققه. عرف المهلهل بجمال وجهه وفصاحة لسانه، أنكب صغيراً على اللهو والتشبيب بالنساء، فأطلق عليه أخوه كليب لقب زير النساء أي جليسهن. تبدل حال المهلهل عقب مقتل أخيه والذي قتله جساس بن مرة حيث ثار غضب المهلهل فأنصرف عن اللهو والشراب، وأوقف حياته على الثأر لمقتل كليب فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة وعرفت "بحرب البسوس" وكان للمهلهل فيها العجائب والأخبار الكثيرة. وكما تبدل حال المهلهل عقب مقتل أخيه كليب تبدل شعره أيضاً فبعد أن كان مقلاً في شعره يقول بيت أو بيتين في الغزل، أصبح شعره أكثر غزارة وكثرت قصائده في رثاء أخيه كليب بما فيها من تهديد وثورة وغضب، ونذكر من هذه القصائد: لَمّا نَعى الناعي كُلَيباً ii أَظلَمَت شَمسُ النَهارِ فَما تُريدُ طُلوعا قَتَلوا كُلَيباً ثُمَّ قالوا ii أَرتِعوا كَذَبوا لَقَد مَنَعوا الجِيادَ ii رُتوعا كَلّا وَأَنصابٍ لَنا ii عادِيَّةٍ مَعبودَةٍ قَد قُطِّقَت ii تَقطيعا حَتّى أُبيدَ قَبيلَةً وَقَبيلَةً وَقَبيلَةً وَقَبيلَتَينِ جَميعا وَتَذوقَ حَتفاً آلُ بَكرٍ ii كُلُّها وَنَهُدَّ مِنها سَمكَها ii المَرفوعا حَتّى نَرى أَوصالَهُم ii وَجَماجِماً مِنهُم عَلَيها الخامِعاتُ ii وُقوعا وَنَرى سِباعَ الطَيرِ تَنقُرُ ii أَعيُناً وَتَجُرُّ أَعضاءً لَهُم ii وَضُلوعا وَالمَشرَفِيَّةَ لا تُعَرِّجُ ii عَنهُمُ ضَرباً يُقُدُّ مَغافِراً وَدُروعا وَالخَيلُ تَقتَحِمُ الغُبارَ ii عَوابِساً يَومَ الكَريهَةِ ما يُرِدنَ ii رُجوعا وقال أيضاً في رثاء كليب كُلَيبُ لا خَيرَ في الدُنيا وَمَن فيها إِن أَنتَ خَلَّيتَها في مَن ii يُخَلّيها كُلَيبُ أَيُّ فَتى عِزٍّ وَمَكرُمَةٍ تَحتَ السَفاسِفِ إِذ يَعلوكَ ii سافيها نَعى النُعاةُ كُلَيباً لي فَقُلتُ ii لَهُم مادَت بِنا الأَرضُ أَم مادَت رَواسيها لَيتَ السَماءَ عَلى مَن تَحتَها ii وَقَعَت وَحالَتِ الأَرضُ فَاِنجابَت بِمَن ii فيها أَضحَت مَنازِلُ بِالسُلّانِ قَد ii دَرَسَت تَبكي كُلَيباً وَلَم تَفزَع ii أَقاصيها الحَزمُ وَالعَزمُ كانا مِن ii صَنيعَتِهِ ما كُلَّ آلائِهِ يا قَومُ ii أُحصيها القائِدُ الخَيلَ تَردي في أَعِنَّتَها زَهواً إِذا الخَيلُ بُحَّت في ii تَعاديها الناحِرُ الكومَ ما يَنفَكُّ ii يُطعِمُها وَالواهِبُ المِئَةَ الحَمرا ii بِراعيها مِن خَيلِ تَغلِبَ ما تُلقى أَسِنَّتُها إِلّا وَقَد خَصَّبَتها مِن أَعاديها قَد كانَ يَصبِحُها شَعواءَ مُشعَلَةً تَحتَ العَجاجَةِ مَعقوداً ii نَواصيها تَكونُ أَوَّلَها في حينِ ii كَرَّتِها وَأَنتَ بِالكَرِّ يَومَ الكَرِّ ii حاميها ويقال عن حرب البسوس أنها من اكبر حروب العرب التي وقعت بين فرعي قبيلة "وائل" بكر بن وائل وتغلب بن وائل، وكانت البداية عندما رأى كليب بن ربيعة وهو من "تغلب" ناقة لخالة جساس من "بكر"والتي تدعى البسوس قد كسرت بيض حمام في حماه كان قد أجاره فرمى ضرعها بسهم، فما كان من جساس إلا أن وثب على كليب فقتله، وكان هذا إيذاناً بفتح باب الحروب لمدة أربعين سنة بين الفريقين. وفاة المهلهل ظلت الحروب مشتعلة بين تغلب وبكر، حتى ملت جموع تغلب من الحرب فصالحوا بكراً ورجعوا على بلادهم، ولم يحضر المهلهل هذا الصلح بل أنه نقضه وعاد مرة أخرى للحرب، فقام بالإغارة على بني بكر، فظفر به عمرو بن مالك أحد بني قيس بن ثعلبة فوقع المهلهل في الأسر وأثناء وجوده في الأسر مر عليه تاجر يبيع الخمر، وأهدى إليه بعض الخمر، فأسرف المهلهل بالشراب واخذ يتغنى بالشعر ومما قاله: طِفلَةٌ ما اِبنَةُ المُجَلِّلِ ii بَيضاءُ لَعوبٌ لَذيذَةٌ في ii العِناقِ فَأِذهَبي ما إِلَيكِ غَيرُ بَعيدٍ لا يُؤاتي العِناقَ مَن في ii الوِثاقِ ضَرَبَت نَحرَها إِلَيَّ ii وَقالَت يا عَدِيّاً لَقَد وَقَتكَ الأَواقي ما أُرَجّي في العَيشِ بَعدَ نَدامايَ أَراهُم سُقوا بِكَأسِ حَلاقِ بَعدَ عَمرٍو وَعامِرٍ ii وَحيِيٍّ وَرَبيعِ الصُدوفِ وَاِبنَي ii عَناقِ وَاِمرِئِ القِيسِ مَيِّتٍ يَومَ أَودى ثُمَّ خَلّى عَلَيَّ ذاتِ ii العَراقي وَكُلَيبٍ شُمِّ الفَوارِسِ إِذ حُممَ رَماهُ الكُماةُ ii بِالإِتِّفاقِ إِنَّ تَحتَ الأَحجارِ جَدّاً وَليناً وَخَصيماً أَلَدَّ ذا ii مِعلاقِ حَيَّةً في الوَجارِ أَربَدَ لا ii تَنفَعُ مِنهُ السَليمَ نَفثَةُ ii راقِ لَستُ أَرجو لَذَّةَ العَيشِ ii ما اَزَمَت أَجلادُ قَدٍّ ii بِساقي جَلَّلوني جِلدَ حَوبٍ ii فَقَد جَعَلوا نَفَسي عِندَ ii التَراقي ولما سمع عمرو بن مالك هذا غضب وأقسم ألا يشرب المهلهل عنده ماء ولا خمر ولا لبن حتى يرد ربيب الهضاب ( وهو اسم جمل له كان أقل وروده في الصيف الخمس أي مرة كل خمسة أيام) ويعني هذا ألا يشرب المهلهل شيئاً إلا بعد خمسة أيام، وعندما رأى بعض قومه أن المهلهل كاد أن يموت من العطش أشاروا عليه أن يرسل فيأتي بالجمل قبل يوم وروده ففعل واتوا به بعد ثلاثة أيام ولكن كان المهلهل قد مات، وجاءت وفاة المهلهل عام 94 ق.هـ -531 م. [/align] |

|
|
|
#35 |
|
(*( عضوة )*)
 |
ابن مـرداس أشجع الناس في شعره
[align=right]
العباس بن مرداس السلمي أحد الشعراء المخضرمين عاصر كل من الجاهلية والإسلام، ومن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من المؤلفة قلوبهم، هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن يحيى بن الحارث بن بهثة بن سُليم ويكنى أبو الهيثم، يقال أن أمه هي الخنساء الشاعرة. كان العباس شاعراً وفارساً ومن سادات قومه، حرم الخمر في الجاهلية وذمه، وروى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وشارك في عدد من غزوات المسلمين فشارك في فتح مكة وغزوة حنين. أعلن إسلامه قبل فتح مكة بفترة قليلة وشارك في المعركة، كما شارك في عدد من غزوات المسلمين فكان يخرج للغزو ثم يعود مرة أخري إلى ديار قومه، كان ينزل ببادية البصرة، وقيل قدم دمشق وابتنى بها داراً . مما قاله في الرسول يــا خــاتَــمِ الـنُـبَـآءِ إِنَّـكَ iiمُـرسَـلٌ بِـالـحَـقِّ كُـلُّ هُـدى السَبيلِ iiهُداكا إِنَّ الإِلَــهَ بَــنــى عَـلَـيـكَ iiمَـحَـبَّـةً فــي خَــلــقِـهِ وَمُـحَـمَّـداً iiسَـمّـاكـا ثُـمَّ الَّـذيـنَ وَفَـوا بِـمـا iiعـاهَـدتَهُم جُـنـدٌ بَـعَـثـتَ عَـلَـيـهِـمُ iiالـضَـحّاكا رَجُــلاً بِــهِ ذَرَبُ الــسِـلاحِ iiكَـأَنَّـهُ لَــمّــا تَــكَــنَّــفَــهُ الــعَــدُوُّ iiيَـراكـا يَغشى ذَوي النَسَبِ القَريبِ وَإِنَّما يَـبـغـي رِضـا الـرَحمَنِ ثُمَّ رِضاكا سأل عبد الملك بن مروان ذات مرة جلسائه من أشجع الناس في شعره، فتكلموا في ذلك فقالوا أشجع الناس العباس بن مرداس في قوله : أَشُـدَّ عَـلـى الـكَـتيبَةِ لا iiأُبالي أَحـتَـفـي كانَ فيها أَم iiسِواها وَلي نَفسٌ تَتوقُ إِلى المَعالي سَـتَـتـلِـفُ أَو أُبَـلِّـغُـهـا iiمُناها موقف لابن مرداس مع الرسول كان لعباس بن مرداس إحدى المواقف الشهيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عقب غزوة حنين، فقام بتوزيع الغنائم فأعطى كل من سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعينية بن حصن، والأقرع بن حابس كل منهم مائة من الإبل، وكان نصيب عباس بن مرداس أقل منهم مما أثار في نفسه الغضب فأنطلق منشداً: فَأَصبَحَ نَهبي وَنَهبُ iiالعُبَيدِ بَينَ عُيَينَةَ iiوَالأَقرَعِ وَقَد كُنتُ في الحَربِ ذا iiتُدرَأُ فَلَم أُعطَ شَيئاً وَلَم iiأُمنَعِ إِلّا أَفائِلَ أُعطيتُها عَديدَ قَوائِمِها الأَربَعِ وَما كانَ حِصنٌ حابِسٌ يَفوقانِ مِرداسَ في iiمَجمَعِ وَما كُنتُ دونَ اِمرِىءٍ مِنهُما وَمَن تَضَعِ اليَومَ لا يُرفَعِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقطعوا عني لسانه فأتم له مائة من الإبل، وقد عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقـال لـه : أتقـول في الشعر؟ فأعتذر وقال : بأبي أنت وأمي إني لا أجد للشعر دبيباً على لساني كدبيب النمل ثم يقرصني كما يقرص النمل فلا أجد بدا من قول الشعر، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. ودعي العباس بن مرداس "بفارس العُبَيد" وهو فرسه مما يدل على اعتداده واعتزازه به، وكان يوصف بالبداوة وأنه لم يسكن أي من مكة أو المدينة، كان دخوله إلى الإسلام بعد رؤية رآها في منامه نهض بعدها حارقاً صنمه ضماراً ومعلناً إسلامه. ويقال عن هذا الحدث أنه كان لوالد عباس صنماً من الحجر يدعى ضماراً أوصى ولده عند وفاته أن يعبده، فإذا بعباس يوماً يسمع منادياً من جوف ضمار يقول: قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي أودى ضمار، وكان يُعبد مرة قبل الكتاب، إلى النبي محمد فما كان من عباس بن مرداس إلا أن أحرق الصنم ضمار، وتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه. لَعَمري إِنّي يَومَ أَجعَلُ iiجاهِداً ضِماراً لِرَبِّ العالَمينَ iiمُشارِكا وَتَركي رَسولَ اللَهِ وَالأَوسُ iiحَولَهُ أُولَئِكَ أَنصارٌ لَهُ ما iiأُولَئِكا كَتارِكِ سَهلِ الأَرضِ وَالحَزنَ يَبتَغي لِيَسلُكَ في غَيبِ الأُمورِ المَسالِكا فَآمَنتُ بِاللَهِ الَّذي أَنا iiعَبدُهُ وَخالَفتُ مَن أَمسى يُريدُ المَمالِكا وَوَجَّهتُ وَجهي نَحوَ مَكَّةَ iiقاصِداً وَتابَعتُ بَينَ الأَخشَبَينِ iiالمُبارَكا نَبِيٌّ أَتانا بَعدَ عيسى iiبِناطِقٍ مِنَ الحَقِّ فيهِ الفَصلُ مِنهُ iiكَذَلِكا أَميناً عَلى الفُرقانِ أَوَّلَ شافِعٍ وَآخِرَ مَبعوثٍ يُجيبُ المَلائِكا جاءت وفاة ابن مرداس أثناء خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. [/align] |

|
|
|
#36 |
|
(*( عضوة )*)
 |
الفرزدق.. شاعر الفخر والهجاء
يعد واحداً من أبرز شعراء العصر الأموي، نظم جميع أنواع الشعر
من مدح وهجاء وفخر وغيرها وكان أكثر شعره في الفخر فكان دائم التفاخر بنسبه وشرف أجداده وآبائه، لقب بالفرزدق نظراً لجهامة وجهه وغلظته ويقال أن لفظ الفرزدق يطلق على العجين أو الرغيف الضخم، عرف الفرزدق بكونه شريف في قومه عزيز الجانب، يحمي من يستجير بقبر أبيه. اسمه بالكامل همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي، أبو فراس وهو شاعر من النبلاء من أهل البصرة في العراق ولد الفرزدق عام 38هـ - 658م في البصرة وبها نشأ، وهو شاعر من شعراء الطبقة الأولي يتم تشبيهه بزهير بن أبي سلمى وهو من شعراء الطبقة الأولي مثل الفرزدق، فزهير في الجاهليين والفرزدق في الإسلاميين. له العديد من الأخبار مع كل من جرير والأخطل وله العديد من المهاجاة معهم، كما عرف عن الفرزدق حبه لآل البيت ومدحه لهم وكانت له عدد من المواقف لنصرتهم ومما قاله فيهم: مُـقَـدَّمٌ بَـعـدَ ذِكـرِ اللَهِ ذِكرُهُمُ فـي كُـلِّ بِـدءٍ وَمَختومٌ بِهِ iiالكَلِمُ إِن عُـدَّ أَهـلُ الـتُقى كانوا iiأَئمَّتَهُم أَو قيلَ مَن شَيرُ أَهلِ الأَرضِ قيلَ هُمُ لا يَـسـتَـطـيعُ جَوادٌ بَعدَ iiجودِهِمُ وَلا يُـدانـيـهِـمُ قَومٌ وَإِن iiكَرُموا هُـمُ الـغُـيوثُ إِذا ما أَزمَةٌ أَزَمَت وَالأُسـدُ أُسدُ الشَرى وَالبَأسُ مُحتَدِمُ لا يُـنقِصُ العُسرُ بَسطاً مِن iiأَكُفِّهِمُ سِـيّـانِ ذَلِكَ إِن أَثرَوا وَإِن عَدِموا يُـسـتَـدفَعُ الشَرُّ وَالبَلوى iiبِحُبِّهِمُ وَيُـسـتَـرَبُّ بِـهِ الإِحسانُ iiوَالنِعَمُ كان الفرزدق يعيش حياته بين الأمراء والولاة متنقلا بين الهجاء والمدح فأحياناً يهجوهم وأحياناً أخرى يمدحهم، فعمل على العيش في الحياة كما يحلو له فقضى عمره ينهل من ملذاتها وترفها. توفى عام 110هـ - 728م في بادية البصرة. مما قاله في التفاخر وتحدى به جرير مِـنّا الَّذي اِختيرَ الرِجالَ iiسَماحَةً وَخَـيراً إِذا هَبَّ الرِياحُ iiالزَعازِعُ وَمِنّا الَّذي أَعطى الرَسولُ عَطِيَّةً أُسـارى تَـميمٍ وَالعُيونُ iiدَوامِعُ وَمِنّا الَّذي يُعطي المِئينَ وَيَشتَري الـغَوالي وَيَعلو فَضلُهُ |

|
|
|
#37 |
|
(*( مشرفة )*)
 |
..
متصفّح رائع جداً جداً , بارك الله فيك مخايل لي عودة إن شاء الله , 
|
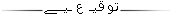
+
الجنَة | وطَن مؤجّلْ .............فَ اللهُمّ إجعلنَا من أهل الفردوسْ . ، 
|
 |
| العلامات المرجعية |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| رأس (حمار) أم رأس (رجل) | بداح فهد السبيعي | ..: المرقاب العَام :.. | 17 | 01-05-2010 03:39 AM |
| كشف شخصيات جديده (1 | نادر العنزي | ..: المرقاب العَام :.. | 54 | 31-03-2010 12:14 AM |
| تحليل شخصيات جديده . . . | نادر العنزي | ..: المرقاب العَام :.. | 40 | 02-02-2010 07:29 PM |
| مجاراة ****سين **** شين**** لحبيب العازمي | عبداللطيف الغامدي | ..: المرقاب للإبْتِكارِ و التّميّز :.. | 35 | 07-10-2008 11:42 PM |
 |
 |